 |
 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
 |
 |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
Thread Tools | Search this Thread | Display Modes |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
ГҮГЎГЈГ’ГҸГЎГқГү ГҘГ* ГғГҚГҸ ГЈГ”ГҮГҡГ‘ ГҮГЎГҚГҢВЎ ГҰГқГ*ГҘГҮ Г*ГӨГ’ГЎ ГҮГЎГҚГҢГҮГҢ ГҲГҡГҸ ГҰГһГҰГқГҘГЈ ГҲГҡГ‘ГқГү ГЎГЎГЈГҲГ*ГҠ ГқГ*ГҘГҮ ГҰГҠГҰГҢГҸ ГҢГЈГЎГү ГЈГӨ ГҮГЎГғГҡГЈГҮГЎ Г*ГӨГҲГӣГ* ГғГӨ Г*ГһГҰГЈ ГҲГҘГҮ ГҮГЎГҚГҮГҢ ГқГ* ГҘГҗГҮ ГҮГЎГЈГ”ГҡГ‘:
1. Г*ГӨГҲГӣГ* ГғГӨ Г*ГҹГҰГӨ ГҮГЎГҸГқГҡ Г…ГЎГ¬ ГЈГ’ГҸГЎГқГү ГҲГҡГҸ ГӣГ‘ГҰГҲ ГҮáÔãÓ ГқГ* Г*ГҰГЈ ГҡГ‘ГқГү ГЎГғГӨ ГҮГЎГӨГҲГ* Õáì ГҮГЎГЎГҘ ГҡГЎГ*ГҘ ГҰÓáã "ГЎГЈ Г*Г’ГЎ ГҰГҮГһГқГҮГ° ГҚГҠГ¬ ГӣГ‘ГҲГҠ ГҮáÔãÓ¡ ГҰГҗГҘГҲГҠ ГҮГЎГ•ГқГ‘Гү ГһГЎГ*ГЎГҮð¡ ГҚГҠГ¬ ГӣГҮГҲ ГҮГЎГһÑÕ¡ ГҰГғГ‘ГҸГқ ГғГ“ГҮГЈГү ГҺГЎГқГҘВЎ ГҰГҸГқГҡ ÑÓГҰГЎ ГҮГЎГЎГҘ Õáì ГҮГЎГЎГҘ ГҡГЎГ*ГҘ ГҰÓáã ГҰГһГҸ Г”ГӨГһ ГЎГЎГһГ•ГҰГҮГҒ ГҮГЎГ’ГЈГҮГЈВә ГҚГҠГ¬ Г…ГӨ Г‘ГғГ“ГҘГҮ ГЎГ*Г•Г*ГҲ ГЈГҰГ‘Гҹ Г‘ГҚГЎГҘВЎ ГҰГ*ГһГҰГЎ ГҲГ*ГҸГҘ ГҮГЎГ*ГЈГӨГ¬: ((ГғГ*ГҘГҮ ГҮГЎГӨГҮГ“: ГҮГЎГ“ГҹГ*ГӨГү ГҮГЎГ“ГҹГ*ГӨГү))ВЎ ГҹГЎГЈГҮ ГғГҠГ¬ ГҚГҲГЎГҮГ° ГЈГӨ ГҮГЎГҚГҲГҮГЎ ГғГ‘ГҺГ¬ ГЎГҘГҮ ГһГЎГ*ГЎГҮГ° ГҚГҠГ¬ ГҠГ•ГҡГҸВЎ ГҚГҠГ¬ ГғГҠГ¬ ГҮГЎГЈГ’ГҸГЎГқГү" Г•ГҚГ*ГҚ ãÓáã (3009)ВЎ ГҰГғГӢГӨГҮГҒ ГҮГЎГҸГқГҡ Г*ГӨГҲГӣГ* ГғГӨ Г*ГҠГҚГЎГ¬ ГҮГЎГҚГҮГҢ ГҲГҮГЎГ“ГҹГ*ГӨГү ГҰГҮГЎГҰГһГҮÑ¡ ГҰГғГӨ Г*ГҠГҢГӨГҲ Г’ГҚГҮГЈ ГҮГЎГӨГҮГ“ ГҰГғГҗГ*ГҠГҘГЈВЎ ГҰГ*ГҹГӢГ‘ ГЈГӨ ГҮГЎГҸГҡГҮГҒ ГҰГҮГЎГҗГҹГ‘ ГҰГҮГЎГҠГЎГҲГ*Гү. 2. ГқГ…ГҗГҮ ГҰÕá Г…ГЎГ¬ ГЈГ’ГҸГЎГқГү Õáì ГҮГЎГЈГӣГ‘ГҲ ГҰГҮГЎГҡГ”ГҮГҒ ГҢГЈГҡГҮГ° ГҲГғГҗГҮГӨ ГҰГҮГҚГҸВЎ ГӢГЈ Г*ÕáГ* ГҮГЎГҰГҠГ‘ ГЎГғГӨ ГҮГЎГӨГҲГ* Õáì ГҮГЎГЎГҘ ГҡГЎГ*ГҘ ГҰÓáã ГҹГҮГӨ Г*ГҚГҮГқГҷ ГҡГЎГ*ГҘ ГқГ* ГҮГЎГҚГ–Г‘ ГҰГҮГЎГ“ГқГ‘[1] ГқГҡГӨ ГҢГҮГҲГ‘ ГҲГӨ ГҡГҲГҸ ГҮГЎГЎГҘ ÑÖГ* ГҮГЎГЎГҘ ГҡГӨГҘ ГқГ* ГҚГҸГ*ГӢГҘ ГҮГЎГҳГҰГ*ГЎ ГқГ* ГҮГЎГҚГҢ ГҰГқГ*ГҘ: "ГҚГҠГ¬ ГғГҠГ¬ ГҮГЎГЈГ’ГҸГЎГқГү ГқÕáì ГҲГҘГҮ ГҮГЎГЈГӣГ‘ГҲ ГҰГҮГЎГҡГ”ГҮГҒ ГҲГғГҗГҮГӨ ГҰГҮГҚГҸ ГҰГ…ГһГҮГЈГҠГ*ГӨВЎ ГҰГЎГЈ Г*Г“ГҲГҚ ГҲГ*ГӨГҘГЈГҮ Г”Г*ГҶГҮГ°" Г•ГҚГ*ГҚ ãÓáã (3009)ВЎ ГӢГЈ Г*ГӨГҮГЈ ГҚГҠГ¬ Г*ГҹГҰГӨ ГЈГҠГҘГ*ГҶГҮГ° ГЎГЎГ*ГҰГЈ ГҮГЎГӢГҮГӨГ* ГҰГҘГҰ Г*ГҰГЈ ГҮГЎГӨГҚГ‘ ГЎГғГӨ ГҹГӢГ*Г‘ГҮГ° ГЈГӨ ГғГҡГЈГҮГЎ ГҮГЎГҚГҢ ГқГ*ГҘ ГҹГҮáÑãГ* ГҰГҮГЎГҚГЎГһВЎ ГҰГҮГЎГҗГҲГҚ ГҰГҮГЎГҳГҰГҮГқВЎ ГҰГҮГЎГ“ГҡГ*ВЎ ГғГЈГҮ ГҮГЎГ–ГҡГқГү ГқГ*ГҲГ*ГҠГҰГӨ Г…ГЎГ¬ ГЈГӨГҠГ•Гқ ГҮГЎГЎГ*ГЎВЎ ГӢГЈ Г*ГҸГқГҡГҰГӨ ГҲГҡГҸ ГҗГЎГҹ. 3. Г*ÕáГ* ГҮГЎГҚГҮГҢ ÕáГҮГү ГҮГЎГқГҢГ‘ ГқГ* ГғГҰГЎ ГҰГһГҠГҘГҮВЎ ГӢГЈ Г*ГһГ•ГҸ ГҮГЎГЈГ”ГҡГ‘ ГҮГЎГҚГ‘ГҮГЈ ГЈГҰГҚГҸГҮГ° ГҮГЎГЎГҘ ГҠГҲГҮГ‘Гҹ ГҰГҠГҡГҮáì¡ ГЈГҹГҲГ‘ГҮГ° ГЎГҘВЎ ГҰГ*ГҸГҡГҰ ГҲГЈГҮ ГғГҚГҲ Г…ГӨ ГҠГ*ÓÑ ГЎГҘ ГҗГЎГҹВЎ ГҰГ…ГЎГҮ ГҰГһГқ ГқГ* ГғГ* ГЈГҹГҮГӨ ГЈГӨ ГЈГ’ГҸГЎГқГү ГЎГғГӨ ГҮГЎГӨГҲГ* Õáì ГҡГЎГ*ГҘ ГҰÓáã ГһГҮГЎ: ((ГҰГһГқГҠ ГҘГҘГӨГҮ ГҰГҢГЈГҡ ГҹГЎГҘГҮ ГЈГҰГһГқ)) ãÓáã (1218)ВЎ ГқГ…ГӨ ГҠГ*ÓÑ ГЎГҘ ГҮГЎГҰГһГҰГқ ГҲГҮГЎГЈГ”ГҡГ‘ ГҮГЎГҚГ‘ГҮГЈ ГқГҘГҰ ГғГқГ–ГЎ ГЎГҚГҸГ*ГӢ ГҢГҮГҲГ‘ ÑÖГ* ГҮГЎГЎГҘ ГҡГӨГҘ: "ГӢГЈ ГҮГ–ГҳГҢГҡ ÑÓГҰГЎ ГҮГЎГЎГҘ Õáì ГҮГЎГЎГҘ ГҡГЎГ*ГҘ ГҰÓáã ГҚГҠГ¬ ГҳГЎГҡ ГҮГЎГқГҢÑ¡ ГҰÕáì ГҮГЎГқГҢГ‘ ГҚГ*ГӨ ГҠГҲГ*ГӨ ГЎГҘ ГҮГЎГ•ГҲГҚ ГҲГғГҗГҮГӨ ГҰГ…ГһГҮГЈГүВЎ ГӢГЈ Г‘ГҹГҲ ГҮГЎГһГ•ГҰГҮГҒ ГҚГҠГ¬ ГғГҠГ¬ ГҮГЎГЈГ”ГҡГ‘ ГҮГЎГҚГ‘ГҮГЈ ГқГҮГ“ГҠГһГҲГЎ ГҮГЎГһГҲГЎГү ГқГҸГҡГҮГҘ ГҰГҹГҲГ‘ГҘВЎ ГҰГҘГЎГЎГҘ ГҰГҰГҚГҸГҘВЎ ГқГЎГЈ Г*Г’ГЎ ГҰГҮГһГқГҮГ° ГҚГҠГ¬ ГғГ“ГқГ‘ ГҢГҸГҮГ° ГқГҸГқГҡ ГһГҲГЎ ГғГӨ ГҠГҳГЎГҡ ГҮáÔãÓ". 4. ГҮГЎГҰГһГҰГқ ГҲГҘГҮ ГЈГӨ ГҲГҡГҸ ÕáГҮГү ГҮГЎГқГҢГ‘ Г…ГЎГ¬ ГғГӨ Г*Г“ГқГ‘ ГҮГЎГ•ГҲГҚВЎ Г*ГҸГҡГҰ ГҮГЎГЎГҘВЎ ГҰГ*ГҗГҹГ‘ГҘВЎ ГҰГ*ГЎГҲГ* Г…ГЎГ¬ ГһГҲГЎ ГҳГЎГҡ ГҮáÔãÓ¡ ГӢГЈ Г*ГҸГқГҡ Г…ГЎГ¬ ГЈГӨГ¬ áÑãГ* ГҢГЈГ‘Гү ГҮГЎГҡГһГҲГү ГҮГЎГҹГҲÑì ГһГҮГЎ ГҠГҡГҮГЎГ¬: {ГқГіГ…Г¶ГҗГіГҮ ГғГіГқГіГ–ГәГҠГөГЈ ГЈГёГ¶ГӨГә ГҡóÑóГқГіГҮГҠГІ ГқГіГҮГҗГәГҹГөГ‘ГөГҰГҮГә ГҮГЎГЎГёГҘГі ГҡГ¶ГӨГҸГі ГҮГЎГәГЈГіГ”ГәГҡóÑö ГҮГЎГәГҚóÑóГҮГЈГ¶ ГҰГіГҮГҗГәГҹГөГ‘ГөГҰГҘГө ГҹГіГЈГіГҮ ГҘГіГҸГіГҮГҹГөГЈГә ГҰГіГ…Г¶ГӨ ГҹГөГӨГҠГөГЈ ГЈГёГ¶ГӨ ГһГіГҲГәГЎГ¶ГҘГ¶ ГЎГіГЈГ¶ГӨГі ГҮГЎГ–ГёГіГӮГЎГёГ¶Г*ГӨГі * ГӢГөГЈГёГі ГғГіГқГ¶Г*Г–ГөГҰГҮГә ГЈГ¶ГӨГә ГҚГіГ*ГәГӢГө ГғГіГқГіГҮГ–Гі ГҮГЎГӨГёГіГҮГ“Гө ГҰГіГҮГ“ГәГҠГіГӣГәГқöÑГөГҰГҮГә ГҮГЎГЎГёГҘГі Г…Г¶ГӨГёГі ГҮГЎГЎГёГҘГі ГӣГіГқГөГҰГ‘Гұ ÑøóГҚГ¶Г*ГЈГұ} (ГҮГЎГҲГһГ‘Гү:198-199). ГҰГҘГӨГҮГҹ ГҢГЈГЎГү ГЈГӨ ГҮГЎГғГҺГҳГҮГҒ Г*ГһГҡ ГқГ*ГҘГҮ ГҲГҡГ– ГҮГЎГҚГҢГ*ГҢ ГҰГ*ГҚГ“ГӨ ГҮГЎГҠГӨГҲГ*ГҘ Г…ГЎГ*ГҘГҮ ГҚГҠГ¬ Г*ГҠГҢГӨГҲГҘГҮ ГҮГЎГҚГҮГҢ: 1. ГҡГҸГЈ ГҠГҚГ‘Г* ГӣГ‘ГҰГҲ ÔãÓ Г*ГҰГЈ ГҡГ‘ГқГүВЎ ГқГ*ГқГ*Г– ГһГҲГЎ ГҮГЎГӣГ‘ГҰГҲ.ГҘГҗГҘ ГҲГҡГ– ГҮГЎГғГЈГҰГ‘ ГҮГЎГҠГ* Г*ГӨГҲГӣГ* ГҡГЎГ¬ ГҮГЎГҚГҮГҢ ГғГӨ Г*ГҠГӨГҲГҘ Г…ГЎГ*ГҘГҮВә ГЎГ*ГҹГҰГӨ ГҚГҢГҘ ÓáГ*ГЈГҮГ° ГҹГҮГЈГЎГҮð¡ ГҰГЈГҰГҮГқГһГҮГ° ГЎГЎГҘГҸГ* ГҮГЎГӨГҲГҰГ* ГҡГЎГ¬ Г•ГҮГҚГҲГҘ ГғГҠГЈ ГҮáÕáГҮГү ГҰГғГ’ГҹГ¬ ГҮáÓáГҮГЈ. ГӨГ“ГғГЎ ГҮГЎГЎГҘ ГҡГ’ ГҰГҢГЎ ГғГӨ Г*ГҰГқГһГӨГҮ Г…ГЎГ¬ ГҹГЎ ГҺГ*Ñ¡ ГҰÕáì ГҮГЎГЎГҘ ГҰÓáã ГҡГЎГ¬ Г“Г*ГҸГӨГҮ ГЈГҚГЈГҸ ГҰГҡГЎГ¬ ГӮГЎГҘ ГҰГ•ГҚГҲГҘВЎ ГҰГҮГЎГҚГЈГҸ ГЎГЎГҘ Г‘ГҲ ГҮГЎГҡГҮГЎГЈГ*ГӨ.
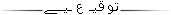

|
| Bookmarks |
|
|
 Similar Threads
Similar Threads
|
||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Г•ГқГү ГҮГЎГҚГҢ (Г‘ГҮГҢГҡГҘГҮ ГҮГЎГ”Г*ГҺ ГҡГҲГҸГҮГЎГЎГҘ ГҲГӨ ГҡГҲГҸГҮГЎГ‘ГҚГЈГӨ ГҮГЎГҢГҲГ‘Г*ГӨ ) | ГқГҘГҸ ГЈГҚГЈГҸ ГҲГӨ ГӨГҮГҚГЎ | ГЈГҢГЎГ“ ГҮГЎГҚГҢ | 3 | Sep-Sat-2014 02:34 AM |
| ГҲГҡГҸ Г*ГҰГЈ ГҲГ•ГҡГ*ГҸ ГҡГ‘ГқГҮГҠ | ГЈГҲГҮГ‘Гҹ | ГҮГЎГҡГңГңГңГңГңГңГңГңГңГңГңГңГңГңГҮГЈ | 2 | Nov-Thu-2010 12:42 AM |
| Г•ГҰГ‘Гү ГЈГҚГҳГү ГһГҳГҮГ‘ ГҮГЎГЈГ”ГҮГҡГ‘ ГҲГЈГҹГү ГҮГЎГЈГҹÑãГү ГҰГЈГЎГқ ГҹГҮГЈГЎ .. | ГҮГ“ГӯГ‘ ГҮГЎГ”ГҰГһ | ГҮГЎГҡГңГңГңГңГңГңГңГңГңГңГңГңГңГңГҮГЈ | 5 | Nov-Sat-2010 02:20 PM |
 |
 |
 |